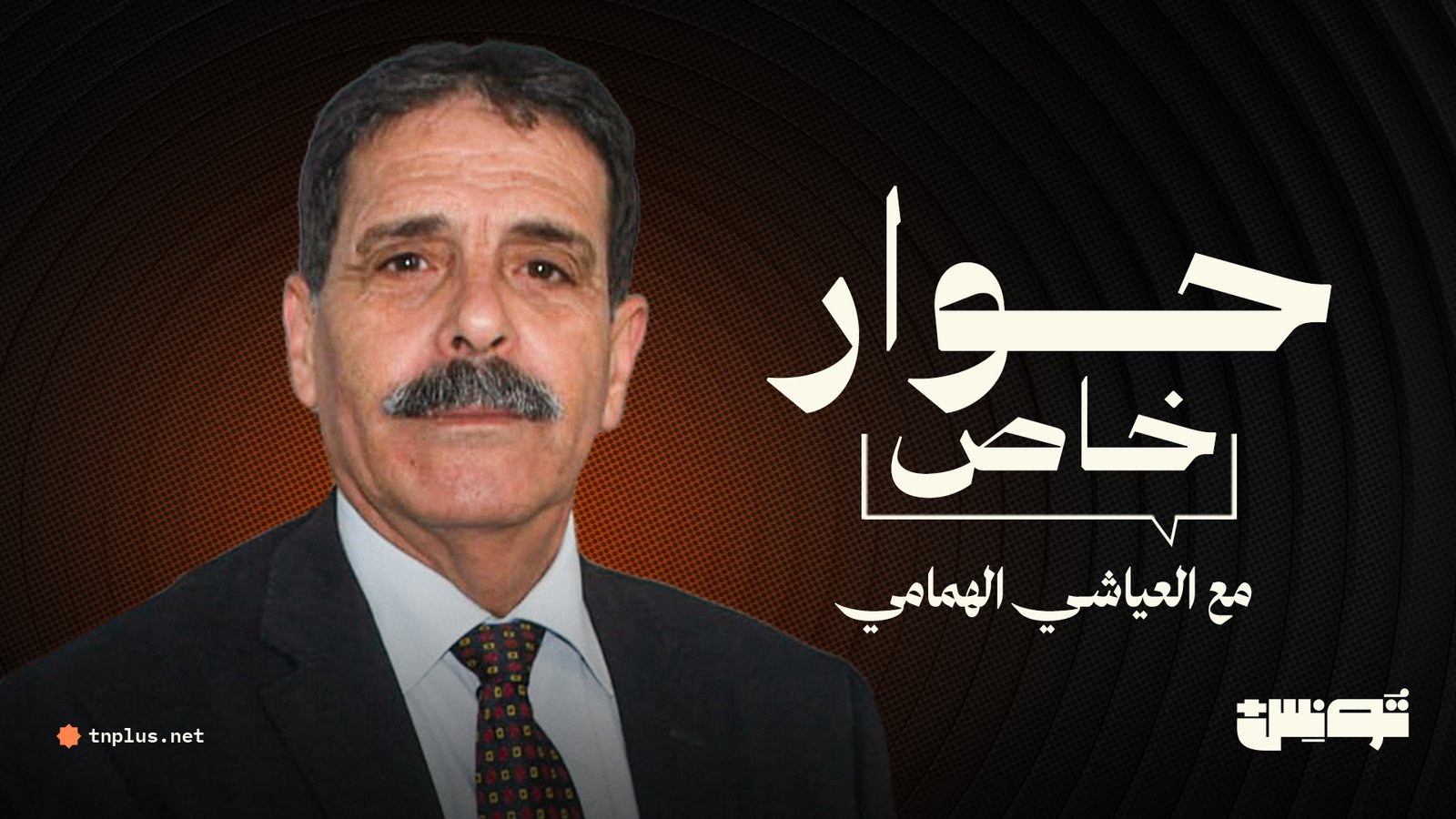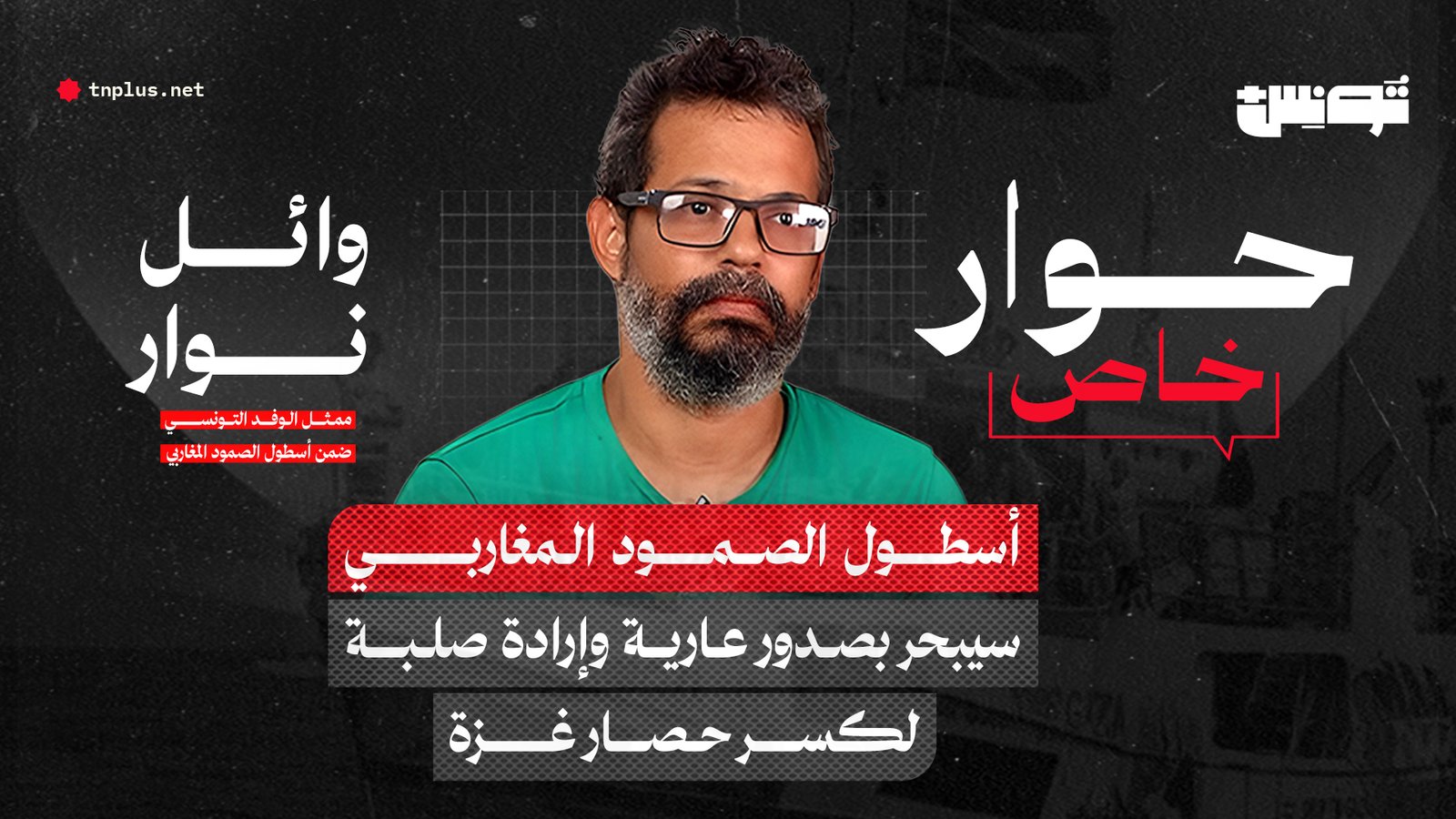تمر تونس اليوم بفترة دقيقة تتسم بتحولات سياسية كبيرة أثرت على أداء مؤسسات الدولة، ولا سيما على استقلالية القضاء ودور المعارضة والمجتمع المدني. ففي ظل تركيز السلطات، ومحدودية الفضاء السياسي، تواجه البلاد تحديات متعددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
في هذا الحوار، نستعرض مع الحقوقي والمحامي التونسي العياشي الهمامي تقييمه للوضع الراهن، وقراءة معمقة لواقع مرفق العدالة، والتحديات التي تواجه المجتمع المدني والمعارضة، بالإضافة إلى مقترحاته لما قد يشكل مسارات محتملة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
بعد مرور أربع سنوات على إجراءات 25 جويلية، كيف تُقيّمون الوضع العام في تونس اليوم على المستويين السياسي والحقوقي؟
تأكد اليوم أن تونس انزلقت إلى نظام دكتاتوري، قائم على حكم فردي مطلق، أثبت عجزه عن تلبية الحاجات اليومية للتونسيين والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل، يمارس القمع على كل صوت معارض أو مختلف معه.
تونس انزلقت إلى نظام دكتاتوري قائم على حكم فردي مطلق عاجز عن تلبية حاجات الشعب، وقمع كل صوت مخالف
هذا المسار لم يكن مفاجئًا، فقد بدأ بانقلاب على الدستور والنظام السياسي، وانتهى بتركيز كل السلطات في يد واحدة. من الواضح أن من يحكم اليوم لا يتصرف كرجل دولة، بل يتحرك بمنطق مرضي، يتعامل مع الشأن العام انطلاقًا من قناعة بأن كل من يحيط به إمّا متآمر أو ضالع في التخطيط للإرهاب أو تهديد الأمن العام.
من خلال ملاحظاتكم، كيف أثرت هذه السياسات على مؤسسات الدولة؟ وما الذي تبقى من البناء المؤسساتي الذي أُنجز بعد الثورة؟
للأسف، قام الحاكم الحالي بتفكيك مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، إمّا عبر حلّها نهائيًا كما حدث مع المجلس الأعلى للقضاء -إذ لا وجود فعليًا له اليوم- أو من خلال الامتناع المتعمد عن تركيزها، كما هو الحال مع المحكمة الدستورية.
لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لعدم تركيز المحكمة الدستورية، خاصة وأن تركيبتها محددة بدقة في الدستور الذي وضعه بنفسه، وأعضاؤها يُفترض أن يُعيَّنوا من بين أقدم رؤساء الدوائر في المحاكم الثلاث التي حددها في دستوره. رغم ذلك، لم يخطُ خطوة واحدة نحو إرسائها، ما يؤكد أن التعطيل ناتج عن إرادته وحده، لا عن مؤامرة ولا عن عرقلة.
هذا التمشي أفضى إلى تفريغ المؤسسات من مضمونها، مع الإبقاء على الأسماء فقط. فمجلس نواب الشعب مثلاً لا يزال موجودًا شكليًا، لكن بصلاحيات منقوصة تُفقده كل معنى وقيمة. لهذا أعتبر أن ما تم إرساؤه هو نظام سياسي هجين، لا يمتّ إلى النظام الجمهوري بِصِلة إلا من حيث التسمية.
ما هو تقييمكم للوضع الحالي للقضاء في تونس؟ وكيف تقرأون الدور الذي بات يلعبه القضاء في المشهد السياسي؟
للأسف، لم يعد للقضاء في تونس اليوم أي هامش من الاستقلالية. فوزيرة العدل باتت تتحكم فيه بشكل مباشر، وتتخذ قرارات بالنقل والعزل دون احترام للضمانات القانونية أو الإجرائية. لم يشهد القضاء التونسي وضعًا بهذا السوء في تاريخه، حيث أصبح بإمكان الوزيرة أن تنقل أي قاضٍ، مهما كانت رتبته أو أقدميته، فقط عبر مراسلة إدارية بسيطة، في تجاوز صارخ لكل القواعد المنظمة للمرفق القضائي.
حتى في حالة اعتبار القضاة مجرد موظفين، لا يمكن نقلهم دون موافقتهم، إلا إذا تعلّق الأمر بعقوبة من الدرجة الثانية، لا تُنفذ إلا بقرار صادر عن مجلس التأديب. ورغم وضوح هذا الإطار، فإنه يُنتهك باستمرار، كما رأينا في حركة النقل الأخيرة التي طالت عددًا من القضاة.
وهذا لا يعني غياب القضاة المستقلين والشرفاء، لكن كل من يُظهر حدًا أدنى من الاستقلالية، يُعاقب ويُبعد عن الملفات الحساسة، وخاصة القضايا السياسية أو محاكمات الرأي. ويُستبدل بمن ينفّذ التعليمات بلا تردد.
القضاء فقد استقلاليته، ووزيرة العدل تتحكم فيه بشكل مباشر، ما يجعل القضاء أداة للقمع
القضاء اليوم هو أحد أبرز المآسي في تونس، لأننا في حالة شاذة حتى مقارنة بالأنظمة الدكتاتورية التقليدية. ففي تلك الأنظمة، عادة ما يبدأ التعسف من الأجهزة الأمنية التي تمارس الإيقاف والتعذيب، ثم تُفبرك الملفات وتُعرض على قضاء خاضع. أما في تونس، فكثير من المعارضين يتم استنطاقهم أمنيًا بشكل روتيني، ثم تُحال ملفاتهم الخاوية على القضاء، ليصدر بحقهم أحكامًا قاسية تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة، دون أي سند قانوني جدّي.
رئيس الجمهورية منح نفسه سلطات لا يمتلكها أي رئيس آخر في العالم. لا توجد أي دولة ديمقراطية أو حتى شبه ديمقراطية، يملك فيها الرئيس صلاحية طرد قاضٍ دون منحه الحق في الاطلاع على ملفه أو الدفاع عن نفسه. هذا ما حصل في ما بات يُعرف بـ”المجزرة القضائية”، حيث تم إعفاء عشرات القضاة بموجب مرسوم رئاسي، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء، إلا أن رئيس الجمهورية ووزيرة العدل يرفضان إلى اليوم تطبيق الأحكام القضائية.
نحن أمام دولة مارقة عن القانون، وأكثر من ينتهك هذا القانون هو من وضعه بنفسه.
كيف يمكن وصف دور القضاء اليوم في قمع المعارضة؟ وهل بات القضاء أداة رسمية للقمع؟
اليوم، أصبح القضاء هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها السلطة لضرب المعارضين وتصفية الرأي المخالف. فالأحكام لا تصدر بناءً على وقائع أو حجج قانونية، بل تُفصَّل بتعليمات تُنقل من رئيس الجمهورية إلى وزيرة العدل، ومنها إلى القضاة. والغاية واحدة: إصدار أحكام جائرة بالسجن ضد كل من يجرؤ على المعارضة أو الانتقاد.
ما نراه اليوم يؤكد ذلك بوضوح: عدد كبير من المعارضين خلف القضبان، وآخرون ملاحَقون قضائيًا، وآخرون صدرت بحقهم قرارات بمنع السفر، وكل ذلك عبر القضاء.
للأسف، هذا هو أسلوب الحكم المعتمد اليوم في تونس: استخدام القضاء كأداة للقمع بدل أن يكون سلطة مستقلة تحمي الحقوق وتضمن الحريات
ما يقوم به قيس سعيّد هو إنتاج نصوص قانونية ثم الضغط على القضاة لتطبيقها بطريقة قمعية وانتقائية. المرسوم عدد 54 أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب السياسيين، والمدونين، والصحفيين، والفنانين، والكتّاب، وغيرهم.
ما يقوم به قيس سعيّد هو إنتاج نصوص قانونية ثم الضغط على القضاة لتطبيقها بطريقة قمعية وانتقائية.. زالمرسوم عدد 54 أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الجميع
المرسوم لا يأتي بجديد من حيث مضمون التهم، فتهم مثل “نشر أخبار زائفة” أو “تشويه السمعة” موجودة أصلًا في القانون التونسي، ولها عقوباتها. لكن المشكلة تكمن في أن السلطة تطالب القضاء بتجاهل القوانين السارية والمناسبة، وتُلزمه بتطبيق هذا المرسوم تحديدًا، حتى في الحالات التي يقتضي فيها القانون تطبيق نص خاص، كما هو الحال بالنسبة للصحفيين.
وفقًا لمبدأ قانوني راسخ، عندما يتوفر قانون خاص وآخر عام، تكون الأولوية لتطبيق القانون الخاص. وبالنسبة للصحفيين، فإن المرسوم 115 هو الذي ينظم مهنتهم ويحدد العقوبات التأديبية عند ارتكاب تجاوزات مهنية. ومع ذلك، تجاهل القضاة هذا المرسوم بالكامل، وتمّت محاكمة الصحفيين بناءً على المرسوم 54، الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى عشر سنوات سجن وخطايا مالية مرتفعة تصل إلى مئة ألف دينار.
الأخطر من ذلك أن النيابة العمومية صارت تبادر بالإيقاف التحفظي مباشرة، قبل حتى صدور الأحكام أو اكتمال الأبحاث، فقط بناءً على التهم الواردة في المرسوم 54.
في المحصّلة، يوظف رئيس الجمهورية القانون والقضاء لإحكام السيطرة على البلاد، وتصفية كل ما يحيط به من معارضة أو صوت مختلف، بهدف خلق فراغ سياسي وقانوني حوله.
كيف يمكننا فهم طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني في ظل ما تتعرض له المنظمات من تضييق وخنق حسب بياناتها؟
التضييق على المجتمع المدني ليس إجراءً معزولًا، بل يندرج ضمن أسلوب الحكم الذي يعتمده قيس سعيّد. فالرجل، ومعه حكومته، أثبتا عجزًا تامًا عن الاستجابة لاحتياجات الشعب، ولم يقدما أي حلول حقيقية للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.
هذا العجز أنتج حراكًا احتجاجيًا متنوعًا، من طرفين أساسيين: من جهة، المواطنون الذين يطالبون بتحسين ظروف العيش، بسبب انقطاع الماء، وتدهور النقل، وضعف الخدمات الصحية وغيرها، ومن جهة ثانية، الفاعلون السياسيون الذين يحاولون تقديم بدائل وبرامج إصلاحية، ويواجهون المنظومة بالنقد.
التضييق على المجتمع المدني جزء من سياسة فشل السلطة في التعامل مع أزمة البلاد، والرد عليها بالقمع
أمام عجزه عن مواجهة هذه الأطراف بالحلول، اختار قيس سعيّد الرد بالقمع والتشويه. خطابه السياسي مبني على التخوين والاتهام بالتآمر، وتفسير فشله دائمًا بالعرقلة والإدارة المتآمرة، وكأنه ليس في موقع المسؤولية، بل في موقع المعارض الأكبر. يُقدّم نفسه كمصلح لم تُتح له الفرصة، لا كصاحب مشروع واضح يتحمل تبعات الحكم.
هذه الطريقة في إدارة الدولة هي، بطبيعتها، ظرفية وهشة، ولا يمكن أن تُنتج نظامًا دائمًا أو مستقرًا. وعندما يُستبدل النقاش بالتهديد، والمنطق بالقمع، تصبح النتيجة الحتمية هي التوتر، لا باعتباره مؤشرًا على القوة، بل كدليل على الضعف والفشل في المواجهة السياسية.
وبما أن رئيس الجمهورية يسيطر على أجهزة الدولة الصلبة، وعلى القضاء، فهو يواصل هذا النهج، لكنّه نهج لا يمكن أن يصمد طويلًا. فمع انعدام أي تحسن اقتصادي أو اجتماعي، تتسع دائرة الغضب الشعبي يومًا بعد يوم، وترتفع نسبة الرافضين لمسار 25 جويلية، في مقابل تقلص واضح في حجم المساندين له.
غير أن تغوّل الرئيس لا يجد ما يردعه اليوم، بسبب تعثر المعارضة وفشلها في تقديم نفسها كبديل موثوق. فقد عاش التونسيون تجربة سياسية مريرة خلال العقد الذي أعقب الثورة، حيث توفرت ديمقراطية شكلية للسياسيين داخل البرلمان وفي المنابر، دون أن تنعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.
حينها، بدأ قطاع واسع من الشعب يفقد الثقة في الديمقراطية، وطالب بما سمّي بـ”المستبد العادل”، لكن المفارقة أن ما حصلوا عليه هو مستبدّ غير عادل، لا يملك مشروعًا ولا حلولًا
هل يمكن القول اليوم إن الدفاع عن الحقوق والحريات في تونس أصبح فعل مقاومة؟ وما هو واقع المعارضة السياسية والمجتمع المدني في هذا السياق؟
نعم، بات الدفاع عن الحقوق والحريات في تونس يُعدّ شكلًا من أشكال المقاومة. فالمعارضة السياسية تراجعت إلى حدّ كبير، وتحوّل دورها في السنوات الأخيرة إلى دور أقرب إلى المنظمات الحقوقية، حيث أصبحت بياناتها تقتصر على المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، أو ضمان حق التظاهر، أو استعادة أبسط الحقوق التي فقدناها تدريجيًا. وكأن الأحزاب السياسية تخلّت عن وظيفتها الأصلية، واكتفت بموقع الدفاع عن الحقوق، دون تقديم بدائل سياسية حقيقية.
عقدة “الإسلاميين” ما تزال تُستثمر سياسيًا، ويُبنى عليها خطاب تبريري للقمع. البعض ما زال يعتقد أنه يمكن أن يكون ديمقراطيًا ويطالب في الوقت ذاته بإقصاء خصومه، متناسيًا أن جوهر الديمقراطية هو الاعتراف بالاختلاف
في المقابل، بدأ جزء من المجتمع المدني يستفيق، رغم أن فئة واسعة منه كانت في البداية إما مساندة لمسار 25 جويلية أو صامتة عنه. وهذه من أخطائنا الكبرى في تونس: الاعتقاد بأن شخصًا انقلب على الدستور يمكن أن يكون مشروعًا للإنقاذ، وهو ما ثبت أنه وهم.
كما أن عقدة “الإسلاميين” ما تزال تُستثمر سياسيًا، ويُبنى عليها خطاب تبريري للقمع. البعض ما زال يعتقد أنه يمكن أن يكون ديمقراطيًا ويطالب في الوقت ذاته بإقصاء خصومه، متناسيًا أن جوهر الديمقراطية هو الاعتراف بالاختلاف، وأن من يقبل بقمع خصومه اليوم، قد يكون هو نفسه ضحية القمع غدًا.
نعم، التحركات الاجتماعية موجودة، وينشط فيها أساسًا المجتمع المدني، وخاصة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن ما يغيب اليوم هو المعنى الحقيقي للمعارضة السياسية. فالتغيير لا تصنعه البيانات الحقوقية وحدها، بل تصنعه السياسة، عبر البرامج والمشاريع البديلة.
ورغم أن دور المجتمع المدني يظل أساسيًا كسلطة مضادة لأي حكم، فإن ما يصنع البديل ويقدّم الأفق هو العمل السياسي. للأسف، لا وجود حقيقي اليوم لمشروع سياسي واضح أو بديل مقنع. حتى الفاعلين السياسيين أصبحوا غارقين في المعارك الحقوقية، بعد أن فرّغت السلطة الفضاء العام من كل إمكانيات العمل السياسي الفعّال.
كيف ترون إمكانية تجاوز الانسداد السياسي الحالي؟ وما هي الخطوات اللازمة لتحقيق انفراج حقيقي على مستوى المعارضة؟
ما نعيشه اليوم هو انسداد تام: من جهة، هناك سلطة حاكمة مركزة في يد شخص واحد، يتحكم في الأجهزة الصلبة للدولة -من الأمن إلى القضاء-، ومن جهة أخرى، معارضة سياسية مشتتة، ضعيفة، وعاجزة حتى عن التوحد حول أبسط الحقوق المشتركة.
لدينا اليوم مساجين من مختلف التيارات: من الدساترة (عبير موسي)، إلى الإسلاميين (راشد الغنوشي)، إلى الديمقراطيين (عصام الشابي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، جوهر بن مبارك…)، ورغم ذلك، لم تنجح هذه الأطراف في النزول معًا إلى الشارع لتقول “لا” لهذا المسار.
لتجاوز هذا الانسداد، لا بد من مواجهة الحقيقة: داخل المعارضة نفسها توجد “سلطة” تتحكم بها؛ قيادات بقيت في مواقعها رغم فشلها، وعجزت عن تقديم مراجعات حقيقية. من حمة الهمامي إلى عبير موسي إلى قيادات أخرى، جميعهم يتحملون جزءًا من المسؤولية.
المعارضة تحتاج اليوم إلى تجديد قيادتها، إلى أجيال شابة متحررة من العقد الأيديولوجية، قادرة على بناء أرضية مشتركة للخروج من الأزمة، وبعدها يمكن للتنافس السياسي أن يعود.
القيادات الحالية داخل المعارضة عاجزة عن التوحد، ومثّلت عائقًا رئيسيًا أمام بناء بديل سياسي حقيقي.. لذلك لا بد من تجديد قيادتها إلى أجيال شابة متحررة من العقد الأيديولوجية، قادرة على بناء أرضية مشتركة للخروج من الأزمة
اليوم لا وجود لشروط التنافس الحقيقي: هناك من هو في السجن، ومن يخاف المواجهة، ومن مُنع من التنقل. السلطة تشنّ حملة تشويه ضد الجميع، لكن رغم ذلك لا تزال قيادات المعارضة ترفض العمل المشترك، وترفض مراجعة ذاتها، وهذا أحد أكبر عوائق التغيير.
أغلب هذه القيادات تجاوزت الستين من العمر، وقد منحتها الثورة فرصة تاريخية، لكنها فشلت في استثمارها، وسمحت بانهيار الثقة في الديمقراطية إلى حدّ صعود شخص شعبوي استولى على الدولة. إن لم تكن هذه التجربة تستدعي مراجعة ونقدًا ذاتيًا، فما الذي يستحق ذلك؟
هناك اليوم جيل جديد، من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، يهتمون بالشأن العام، ويحبون البلاد، وهم يمثلون الأمل الحقيقي. لكنهم لم يُطوّروا بعد تجارب كافية لصياغة “ذات سياسية” جديدة قادرة على القيادة. دورنا، نحن من سبقناهم، إذا أردنا أن نكون إيجابيين، هو مرافقتهم، لا بالوصاية، بل بالتجربة والنصح، ونحافظ معهم على جذوة الرفض الحيّ للظلم.
وعليهم أن يتجاوزوا العقد القديمة التي كبّلت الأجيال السابقة: لا يجب أن يكون معيار العمل المشترك هو الخلفية الأيديولوجية؛ هل هو إسلامي، شيوعي، قومي؟ بل يجب أن يكون المعيار هو الإيمان بالديمقراطية والتنمية.
ما نحتاجه اليوم هو الحد الأدنى من الدولة: دولة تحترم رأي المواطنين وتوفّر لهم أساسيات العيش الكريم. فالديمقراطية بدون تنمية لا تصمد، والتنمية بدون ديمقراطية لا تدوم.
على التونسيين أن يتفقوا على قاسم مشترك: ضمان الحريات من جهة، وتحقيق الكرامة من جهة أخرى. والكرامة تعني شيئين بسيطين وأساسيين: أن يُحترم رأيك، وأن تتمتع بحقوقك الدنيا. هذا ما نأمله للأجيال القادمة.
في ضوء هذه التحديات، كيف ترون أهمية الوحدة الوطنية والتوحد بين مختلف الأطراف السياسية؟ وما هو دورها في تحقيق التغيير؟
يجب أن نستمر في محاولة تقريب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة واحدة مشتركة. فمثلما يُقال، ما لا يُحقَّق بالنضال يأتي بمزيد من النضال. حتى الآن، فشلنا في تحقيق الوحدة المنشودة، لكن لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في المحاولة والبحث عن أرضية مشتركة تمكّننا من التقدم.
ما لا يُحقَّق بالنضال يأتي بمزيد من النضال. حتى الآن، فشلنا في تحقيق الوحدة المنشودة، لكن لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في المحاولة والبحث عن أرضية مشتركة
الوحدة ليست مجرد شعور أو فكرة، بل هي شرط ضروري ومنطقي. فالعصا الواحدة تُنكسر بسهولة، لكن خمس عصيّ مجتمعة في يد واحدة يصعب كسرها. عندما نتحد، لن يستطيع الحاكم كسر إرادتنا، وسنتمكن آنذاك من إحراز تقدّم حقيقي.
شخصيًا، قضيت حياتي وأنا أسعى للتوحيد من أجل أن نكون أقوى، لكن من المهم أن نستلهم العبر من الماضي، ونُقرن المطالب الديمقراطية بالحرص على التنمية. يجب أن يشعر المواطن أن السياسي يتوجه إليه مباشرة، وليس أن يتحدث عن نفسه فقط، كما كان حال المشهد السياسي في السنوات العشر التي أعقبت الثورة.
في النهاية، هذا هو طريقنا، وطالما كان لحياتنا معنى، فلابد أن نظل رافضين للظلم، نبحث عن التغيير، ونتمسك بالأمل.